
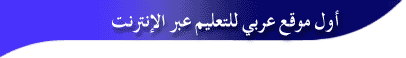

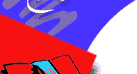

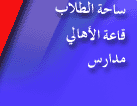
الصفحة الرئيسة <غرفة المعلمين<نظريات
نظريات
التعلم
|
|
تعتبر
نظريات التعلم في سلم الأولويات بين
النظريات التربوية من حيث كونها تفسر
سلوك الكائنات الحية. ومن النظريات
القديمة المفسرة لكيفية حدوث التعلم: 1-
نظرية تداعي الأفكار: ويرجع
تاريخ هذه النظرية إلى أيام أرسطو،
ومفادها أن ما يكتسب من العلم الجديد
يندمج غالباً مع الخبرة القديمة لدى
المتعلم، ليتكون منهما كتلة عملية
موحدة تشكل بنية تحتية لما يستجد من
المعلومات والخبرات الجديدة. ويرى
أصحاب هذه النظرية أن الإنسان يسهل
عليه تذكر الأشياء إذا تداعت في ذهنه
فيستدعي بعضها بعضاً، وخصوصاً أن من
أساليب التفكير عند الإنسان أن
الأشياء تتداعى إذا كان بينها تقارب أو
تتابع أو تماثل أو تخالف. وقد
برز كثير من
المربين المعاصرين ممن ناصروا هذه
النظرية أمثال جون لوك، وتوماس براون،
ويوحنا هربارت الذي بنى طريقته في
التعليم على أساس
(المقدمة أو
التمهيد فالعرض، فالصهر, فالتعميم أو
التطبيق). 2-
نظرية الأفكار الكامنة: مفاد
هذه النظرية أن التعلم عملية تستعاد
فيها من ذاكرة المتعلم أفكار كانت
موجودة لديه قبل ولادته، ولكنها كانت
في طور الكمون، ولهذا فليس على المعلم
سوى تنبيه هذه الأفكار من رقادها كما
يولد الجنين الكامن في رحم أمه. وعلى
رأس المنادين بهذه النظرية سقراط و
تلميذه أفلاطون. إذ يرى سقراط أن تراكم
ظروف الحياة، وما يرثه الإنسان من
عادات يشكل مجموعة تشبه طبقة من الصدأ
في النفس كما الصدأ على الحديد والغبار
على المرآة. فعمل المعلم هو إزالة
إزالة هذا الصدأ والغبار عن المرآة
وتجليتها. ولهذا
كان سقراط يعلن أنه لا يعلّم الناس
شيئاً ولكنه يبحث وإياهم عن الحقائق
الكامنة في النفس ذاتها. أما أفلاطون فيرى الإنسان مركباً من جزئين: الجزء الأول المادي، والثاني هو النفسي أو السماوي المنسوب إلى عالم المثل. و يرى أفلاطون أن النفس حين تنزل من السماء الى الأرض لتتحد مع جسمها فإنها تفقد كثيراً من المعارف، ولذلك فإن النفس في العالم المادي لا تتعلم أشياء جديدة بل تتذكر أشياء قديمة. وتكون وظيفة المعلم محصورة في مساعدة الطالب على تذكر ما كان عالقاً في نفسه أيام ما كانت في عالم المثل
|
|
|
|
|